الرومانسية من الكلمات المحبَّبة للبشر، وكثيرًا ما كُتبت فيها أشعار وروايات، وتحولت إلى أفلام ومسلسلات، وبقيت حلمًا كبيرًا للشباب، وخصوصًا الفتيات.
ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن أصل كلمة رومانسية من الكلمة اللاتينية رومانيكاس Romanicus ولم يكن مقصودًا بها مشاعر الحب، لكنها كانت تصف الملاحم الشعبية وبطولات القرون الوسطى، وارتبطت بمشاعر الإنسان الثورية كرد فعل على الثورة الصناعية التي كانت تستعبد البشر وتعتبرهم مجرد آلات.
ومن هنا بدأت الرومانسية (أو الرومانتيكية) تنتشر في كل فروع الحياة، فتُعلي من أهمية الحسّ والعاطفة والخيال على حساب العقل والمنطق، وقد اختزلها البعض في طرق محددة للتعبير عنها (ورود أو دباديب)، ولغات محددة (الهدايا والمشاركة والكلام وتقضية الوقت والتلامس)، وفي يوم محدد (valentine day)، حتى أصبحت الرومانسية تجر تجارة هائلة لكُبرى الشركات، والتي تستغل احتياج البشر المشروع للحب في ترويج منتجاتها، ففي عام ٢٠٢٢ أنفق الأمريكان ٢٣.٩ مليار دولار على هدايا عيد الحب.
ولكن نتساءل وهل في الحب مشكلة؟ وما دخل إبليس في هذا الأمر الجميل؟
مصدر الحب

أول ما يفعله إبليس في هذا الأمر هو قلب الحقائق، فهو يروِّج أن الله ضد الحب والرومانسية، وأنه – أي إبليس- هو الراعي الرسمي لكل المُحبين، ولذا فإذا أردت أن تستمتع بقصة حُب ابعد عن الله.
وهذا هو الكذب بعينه، لأن الحُب قبل أن يكون احتياجًا إنسانيُا مُلحًا، فهو أصلاً طبيعة الله «وَمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ، لأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ» (١يوحنا٤: ٨)، وقد وضع الله الخالق نماذج طبيعية من محبته، بدءًا من الأب الذي يسدد احتياجات أسرته ويوفر لهم الأمان، والأم التي تتحنن على صغارها وتعزيهم، والصديق الذي يشارك ويدعم ويسند، وصولاً إلى حتى الحيوانات التي تترفق بُحب على صغارها.
وبما أن إبليس هو عدو الله (متى١٣: ٣٩)، فهو لا يعرف الحب؛ لأنه على النقيض من الله مصدر الحب، بل هو «قَتَّالاً لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدْءِ» (يوحنا٨: ٤٤)، ولم يُمارس لغات الحب الخمسة، لكنه يُمارس لغات البُغضة الثلاث فهو «يَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ» (يوحنا١٠: ١٠)، ولهذا لا عجب أن يرتكب بعض البشر أبشع الجرائم (اغتصاب وقتل وسرقة وابتزاز وغيرها)، تحت ستار الحُب “الإبليسي” طبعًا.
ولا يكتفي إبليس بتشويه مصدر الحب، لكنه يشوهِّ مفهومه في أذهان الكثيرين -وخصوصًا الشباب - فجعله مجرد حالة هيام دون أي التزام، ومجرد شعور دون أي وعي، واستخدم في ذلك وسيلتين عصريتين؛ الأولى هي تسليط الضوء على قصص حُب المشاهير، سواء في الماضي أو الحاضر، وتصديرها على أنها نموذج الحُب الحقيقي، ويخفي ما بداخلها من صنوف الخيانة والغدر والأنانية، والتي تنتهي غالبًا بالفشل. والثانية هي السوشيال ميديا، عبر مُجاهرة البعض المستمرة بالحب لأحبائهم “عمَّال على بطال”، وفي رأيي أنها وسيلة دفاعية لإخفاء المشاكل الحقيقية في العلاقات، لأن المشاعر العميقة غالبًا تَخجَل من الصعود للعَلَن.
مفهوم الحب
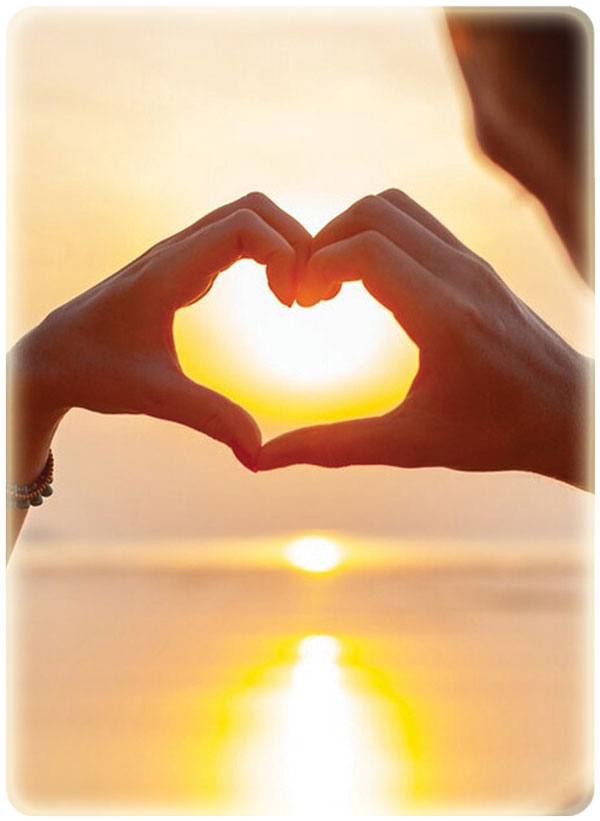
لكن شكرًا للرب من أجل كلمته، التي شرحت لنا مفهوم الحُب الحقيقي، سواء عَبْرَ ذِكر بعض النماذج السيئة للحُب دون أي حرج أو مجاملة، مثل حُب أمنون لثامار الذي كان هيامًا مرضيًا استولى على عقله وأمرَض جسده، وتحول في النهاية إلى جريمة اغتصاب مقذِّذة، ثم ثأر وقتل من أخ لأخيه (٢صموئيل ١٣)، ومثل حُب المرأة الأجنبية الشريرة الهادف فقط للذة الحسية وهي قائلة لضحيتها الشاب: «هَلُمَّ نَرْتَوِ وُدًّا إِلَى الصَّبَاحِ. نَتَلَذَّذُ بِالْحُبِّ» (أمثال٧: ١٨)، وتحوَّلت إلى مرار وحصاد وجروح بلا شفاء.
أو عَبرَ ذِكر الكتاب المقدس لقصة حب حقيقية أشرف عليها وأسسها الله، وأثمرت أول قصيدة رومانسية في التاريخ «فَقَالَ آدَمُ: هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تُدْعَى امْرَأَةً لأَنَّهَا مِنِ امْرِءٍ أُخِذَتْ» (تكوين٢: ٢٣)، فالحب الحقيقي عطاء وليس أخذ، خروج عن الذات وليس أنانية وتمحورًا حولها، بذل للغالي وليس إهداءً شكليًا للرخيص، اهتمام برضا الطرف الآخر وليس بالطرف الثالث (لايكات السوشيال ميديا).
ولا يمكن أن نتكلم عن الحب الحقيقي إلا ونذكر أعظم وأكمل مثال له، وهو ما فعله المسيح (العريس) معنا نحن (عروسته ومحبوبته)، فلم يُحبنا بلغات المحبة المعروفة بالكلام أو المشاركة أو الهدايا، مع أن هذه الأمور كانت نعمة كبيرة لا نستحقها، لكن المسيح عبَّر عن حُبه بتقديم نفسه لنا، كما قال: «لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ» (يوحنا١٥: ١٣)، وعلى من يرغب في الحب الحقيقي أن يتعرف به ويشبع من نبعه، وإلا فلن يرويه أي حب آخر.